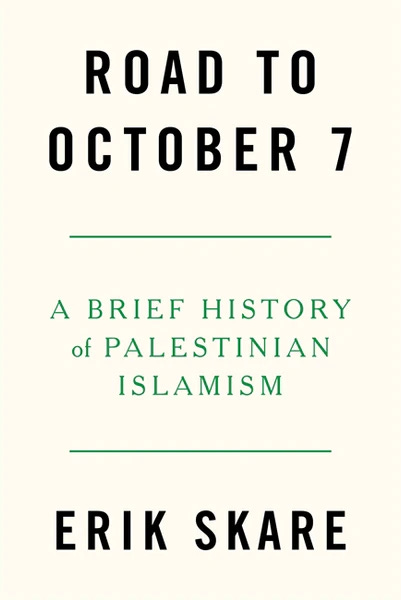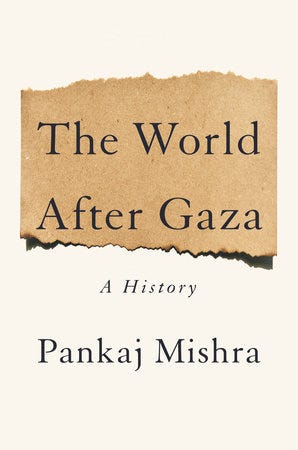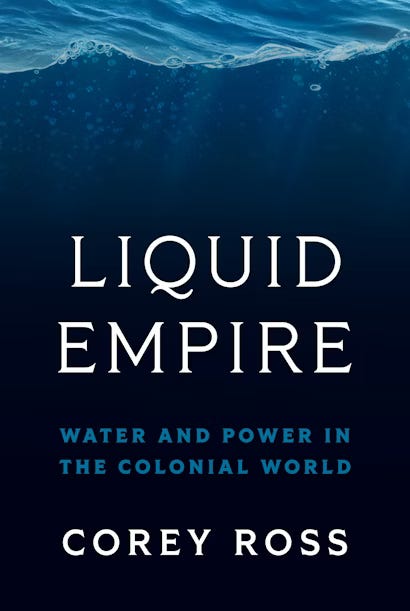نشرة الدالّ للكتب | العدد 19
نشرة الدالّ
تأتيكم بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية
نرحب بكم في العدد التاسع عشر من نشرة "الدالّ" التي نستعرض فيها نصوصاً تعريفية باللغة العربية لكتب تتناول قضايا ومواضيع مختلفة من وعن الشرق الأوسط والعالم.
نُؤمن بأنّ المعرفة تُبنى من خلال التشارك والتفاعل. لذا، ندعو الجميع للاشتراك في "الدالّ" والتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: newsletter@al-salon.com - للمساهمة في إثراء محتوى النشرة وتطويرها بما يُلبي احتياجاتكم وتطلّعاتكم.
إلى اللقاء في العدد القادم!
*تنويه: تستقي النشرة النصوص التعريفية الموجودة أسفل كل كتاب من مواقع دور النشر، مع الحفاظ على جميع حقوق الناشر. يقتصر دور فريقنا على اختصار هذه النصوص وعرضها أو ترجمتها دون أي تعديل أو إضافة.
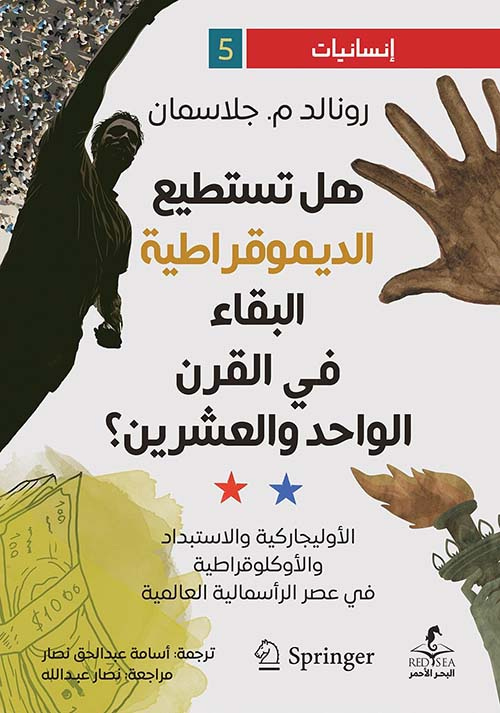
نشر هذا الكتاب للمرة الأولى باللغة الإنجليزية عام 2021 عن سبرينجر.
"هل تستطيع الديموقراطية البقاء في القرن الواحد والعشرين؟ الديمقراطية حلم الكثيرين في العالم المعاصر، ولكن أين هي؟ وهل يساء استعمالها؟ لماذا تدعم الديمقراطيات الغربية الأنظمة الاستبدادية في باقي العالم؟ وهل الديمقراطية الغربية هي ديمقراطية انتقائية؟ ديمقراطية للإنسان الأبيض فقط؟ هل ظلت الهند بنظامها الحالي الدي يُقصي غير الهندوسي ديمقراطي، أم تحولت إلى أوكلو قراطية؟ وما هي هذه الأخيرة؟ وهل تعتبر بريطانيا القرن التاسع عشر ديمقراطية أو أوليجاركية؟ وهل إيران ديمقراطية رغم مرجعية الفقيه؟ يلجأ المؤلف في البداية إلى سرد تاريخ الديمقراطية منذ أطوارها الأولى - مستخدماً مباحث الإنثربولوجيا - في مرحلة القبيل ثم إلى التجمعات البشرية التالية في المدن الأولى ووصل بها إلى الديمقراطية الأثينية مرورًا بأشكالها المختلفة، ثم قام بعدها برحلة طويلة في أنظمة الحكم الأوروبية في العصور الوسطى في هولندا وألمانيا وإنجلترا حتي انتهي في آخر الرحلة إلى صيغتها الحالية. يطرح المؤلف بعد ذلك أسئلة كثيرة حول المخاطر التي تحيق بالديمقراطية وفكرتها، ويولي أهمية كبيرة في هذا للعامل الاقتصادي غير غافل عن تأثير الاجتماع والعقيدة. يضرب كذلك أمثلة على ديمقراطيات أوروبية مثل بولندا والمجر، وكيف أنها تغذي الشعور القومي في مواطنيها بأن تلجأ إلى تخويفهم من ضياع الهوية القومية إذا ما فتحت أبوابها للآخرين من البلاد الأجنبية، كما بتوقف طويلا عند أنظمة حكم مثل الصين والهند ويربط وصولها إلى المطية المكتملة بتحقق بضع شروط مجتمعية يفضلها عندما يقدم لنا في نهاية الكتاب روشتة الحفاظ على الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين، فهل تستطيع الديمقراطية أن تبقي؟ كتاب يهم الجميع قراءته بوعي ورغبة مخلصة في الإصلاح."
مراجعة للكتاب: الوطن
يرى إريك سكارفي هذا الكتاب أن الإسلاموية/الإسلام السياسي الفلسطيني أكثر تعقيدًا وديناميكية مما يُفترض عادةً. فقد تطوّر هذا التيار باستمرار من خلال الخلافات بين المعتدلين والمتشددين. وغالبًا ما حُسمت هذه الصراعات بعوامل خارجية مثل التنافس الداخلي الفلسطيني، والعنف والقمع الإسرائيلي، أو التغيرات في موازين القوى الإقليمية.
لقاءات مع الكاتب: بودكاست التحرير - POMEPS, Tahrir Podcast
*لم يرد هذا الوصف عن الكتاب من قبل دار النشر، وتم استخدام مراجعة الصالون لوضع الوصف التالي*
يعتمد هذا الكتاب على أرشيف محاضر جلسات الحكومة الإسرائيلية التي سُمح بالكشف عنها عام 2017، والتي توثق النقاشات السياسية والأمنية التي دارت عشية وبعد حرب عام 1967. تتناول الوثائق السياسات التي وُضعت تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءًا من خطط الاحتلال والضم، مرورًا بالتحكم العسكري، ووصولًا إلى قضايا السكان واللاجئين وإعادة رسم الخرائط الديموغرافية.
يُظهر الأرشيف كيف شكّلت هذه النقاشات الأساس لرؤية إسرائيل طويلة الأمد للسيطرة على الأرض والسكان، من خلال فرض أنظمة عسكرية وإدارية هدفت إلى إضعاف البنية الاجتماعية الفلسطينية وإعادة تنظيمها وفق متطلبات الحكم الإسرائيلي. كما تسلط الوثائق الضوء على النقاشات الداخلية حول مستقبل القدس، وغزة، والضفة الغربية، إضافة إلى خطط التعامل مع اللاجئين، والسيطرة على الموارد، وتثبيت "الحقائق اليهودية" على الأرض.
يكشف المحتوى عن منطق الهيمنة الذي لم يقتصر على القرارات العسكرية والسياسية، بل امتد إلى أدوات الضبط السكاني والإحصاء والسيطرة على تفاصيل الحياة اليومية، ويبيّن كيف تم تحويل الأوامر الحكومية إلى واقع ملموس أعاد تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية.
مراجعات للكتاب: الصالون، الملتقي الفلسطيني، الميادين، موطني 48
لقد تشكّل النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، في نواحٍ كثيرة، كردّ فعل على الهولوكوست. فقد أصبح هذا الحدث مقياسًا للفظائع، وفي المخيال الغربي، هو النموذج النمطي للإبادة الجماعية. لقد أصبحت هذه الذاكرة الغربيةتوجّه الكثير من التفكير للبعض، وتشكل، على نحو حاسم، الأساس الأخلاقي لحق إسرائيل أولًا في أن تؤسّس نفسها، ثم في أن تدافع عن وجودها. لكن في أجزاء كثيرة من العالم، التي مزقتها صراعات أخرى وتجارب من المجازر الجماعية، لا يُسلَّم دومًا بتفرّد الهولوكوست عندما يُقرّ بهولها وبشاعتها. يرى بانكاج ميشرا أنه خارج الغرب، فإن القصة المهيمنة للقرن العشرين هي قصة إنهاء الاستعمار.
يتخذ الكتاب الحرب الحالية في غزة وردود الفعل المستقطبة عليها كنقطة انطلاق لإعادة تقييم واسعة لسرديتين متنافستين عن القرن الماضي: رواية الشمال العالمي المنتشية بالانتصار على الشمولية وبنشر الرأسمالية الليبرالية، ورؤية الجنوب العالمي المفعمة بالأمل في تحقيق المساواة العرقية والتحرر من الاستعمار. وفي لحظة يشهد فيها ميزان القوى العالمي تحوّلًا ملحوظًا، ولم يعد الشمال العالمي يحتكر السلطة العليا، يصبح من الضروري للغاية أن نفهم كيف ولماذا أخفق شطرا العالم في التفاهم.
ومع انهيار المعالم القديمة والنقاط المرجعية، لا بد من تبنّي تاريخ جديد، بتركيز مختلف جذريًا، ليعيد توجيه بوصلتنا نحو العالم ورؤى العالم الناشئة اليوم. في هذه الأطروحة القوية والمركّزة، يتصدى ميشرا لأسئلة جوهرية تفرضها أزمتنا الراهنة حول ما إذا كانت بعض الأرواح تُعتَبر أهم من غيرها، وكيف تتكوّن الهوية، وما الدور الذي ينبغي أن تؤديه الدولة القومية.
مراجعات للكتاب: The Guardian, The Markaz Review, Foreign Policy, NYT
لقاءات مع الكاتب: Wheeler Centre, Democracy Now, Middle East Eye, Chris Hedges
نشر هذا الكتاب للمرة الأولى باللغة الإنجليزية عام 2023 عن دار نشر هايماركت للكتب.
"ارتفعت حدّة التحذيرات من ’حرب باردة جديدة‘ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
يؤكّد جلبير الأشقر في هذا الكتاب أنّ الحرب الباردة لم تنتهِ مع انهيار الاتحاد السوفييتي، إنما أخذت أشكالاً جديدة في القرن الجديد. فَسَعيُ الولايات المتحدة إلى ترسيخ هيمنتها العالمية في العقد الأخير من القرن الماضي على حساب روسيا والصين، قد دفع هاتين الدولتين إلى التقارب وأدّى إلى إعادة إطلاق ’الحرب الباردة‘ بصيغة جديدة وتداعيات كارثية.
كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ هل كان ذلك محتماً؟ هل يكتب الاستعدادُ الدائم للحرب لدى القوى العالمية العظمى قصةَ القرن الحادي والعشرين؟ مع سعة الاطلاع ودقة التحليل، يخلص الكاتب من تشخيص المشهد العالمي الجديد إلى تصوّر ملامح عالم بديل يسود فيه السلام والقانون الدولي".
مراجعة للكتاب: RS21، إيطاليا تلغراف، المدن
لقاءات مع الكاتب: Democracy Now, Haymarket Books, New Lines Magazine
سيطرت مجموعة قليلة من الدول الأوروبية القوية في القرنين التاسع عشر والعشرين على أكثر من ثلث مساحة اليابسة على كوكب الأرض. وقد شملت هذه الإمبراطوريات المترامية الأطراف، إلى جانب الغابات المطيرة والصحارى والسافانا، بعضًا من أعظم الأنهار والبحيرات والمستنقعات والبحار في العالم. يروي الكتاب قصة كيف شكّلت المياه في العالم الاستعماري تاريخ الإمبريالية، وكيف لا يزال هذا الماضي الإمبراطوري يلاحقنا حتى اليوم.
يصف كوري روس عبر تغطيته للإمبراطوريات الأوروبية الكبرى في تلك الحقبة، كيف غيّرت الأفكار والتقنيات والمؤسسات الجديدة طريقة تفاعل البشر مع المياه، وكيف أعيد تشكيل العالم الطبيعي خلال هذه العملية. فقد كانت المياه ميدانًا للسلطة الإمبريالية، وكان التحكم فيها وتوزيعها مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالتراتبيات الاستعمارية وعدم المساواة -لكن هذا المورد الطبيعي الحيوي لم يكن من الممكن ترويضه بالكامل. يصوّر روس بشكل حيّ جهود المسؤولين والمهندسين والصيادين والمزارعين لاستغلال المياه، ويبرز الدور الحاسم الذي لعبته في بناء النظام الاستعماري وتفكيكه.
يقدّم كوري منظورًا تاريخيًا ضروريًا لفهم الأزمات التي تكتسح مياه العالم اليوم، كاشفًا عن كيفية استمرار إرث الإمبراطوريات حتى بعد انحسار الاستعمار، وخاصة في الجنوب العالمي، حيث يواجه مليارات البشر نقصًا متزايدًا في المياه، ومخاطر متصاعدة من الفيضانات، واستنزافًا لا يتوقف للحياة البحرية.
مراجعة للكتاب: ISSR
لقاء مع الكاتب: New Books Network